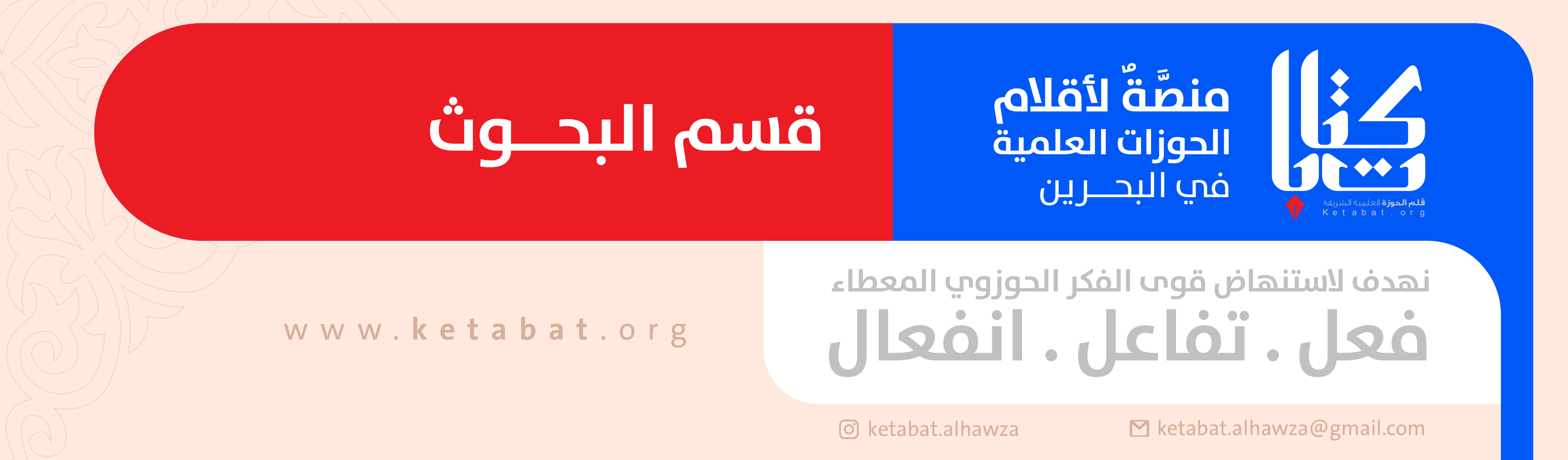
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمَّد وآله الطيبين الطاهرين
التمام في (تسبيحة الإتمام)
تدين هذه الرِّسالة إلى عَلَّامَةِ البَحْرَين الشَّيخ حُسين ابن الشَّيخ محمَّد مِن آل عُصفور[1] (رحمه الله)؛ إذ أنَّ نَظَرَ التتبُّع لم يقف على أحد قبله قد قال بوجوب ما يُعرَف بـ(تسبيحة الجبر) في دبر الفريضة المقصورة غير الشَّيخ الأقدم أبي جعفر الصدوق (رحمه الله) كما يظهر من قوله "وعلى المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصرها ..." الَّذي كاد يُنسَى لولا فتوى الشَّيخ حُسين وإشارته إليه في صريح كلامه؛ ما بعثني على تتبُّع المسألة والنظر في أدِلَّتها وما قاله الأعلامُ فيها.
قال الشَّيخ العصفوري (رحمه الله): "أن يُسبِّحَ بالتسبيحات الأربع؛ وهي: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر) عُقَيب كلِّ فريضة تامَّة ومقصورة ثلاثين مرَّة، وهو بعد المقصورة يكون جبرًا لقصرها، والمشهور بين الأصحاب ما ذكره المُصنِّفُ[2] الاستحباب، وظاهر الصَّدوق الوجوب، وهو المُختار كما في الخبر المروي عن المروزي، قال: قال الفقيه العسكري (عليه السَّلام): يجب على المُسافر أن يقول على دُبر كلِّ صلاة يقصر فيها (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر) ثلاثين مرَّة لتمام الصَّلاة"، ورواه الصدوق في العيون عن رجا بن أبي الضحاك عن الرضا (عليه السَّلام) "أنَّه كان يقول بعد كلِّ صلاة يقصرها (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر) ثلاثين مرَّة، ويقول: هو من تمام الصَّلاة"[3].
أمَّا استظهاره الوجوب من عبارة الشَّيخ الصدوق فلقوله: "وعلى المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصرها: (سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر) ثلاثين مرة لتمام الصلاة"[4]؛ وحَمْلِهِ (على المسافر) على الوجوب والإلزام.
نظرتُ في كلمات فقهائِنا الأخباريين فلم أجد منهم مَنْ قال بالوجوب، فها هو الحرُّ العامليُّ أبو جعفرٍ محمَّد بن الحسن (رحمه الله) يقول: "باب استحباب الإتيان بالتسبيحات الأربع عُقَيب كلِّ صلاةٍ مقصورة ثلاثين مرَّة"[5]؛ وعنوان الباب فتواه (رحمه الله)، وغارس الحدائق (رحمه الله) إذ يقول: "يُستحبُّ جبر المقصورات بالتسبيحات الأربع المشهورة في دبرها"[6]، وكذا أخوه الشَّيخ محمَّد وهو والد شيخنا صاحب السَّداد، إذ يقول: "فيُستَحبُّ له جبر كلِّ صلاة يصليها قصرًا بعد فراغه منها بقوله: ..."[7]، وقال صاحب المُعتَمَد (رحمه الله): "يُستَحَبُّ جبرُ المقصورةِ بالتسبيح ثلاثين مرَّة بعدها استحبابًا مؤكَّدًا، ولا يَجب كما قيل نادِرًا عن بعض مشايخِنا"[8].
ومِنْ فقهائِنا الأصوليين كاد السَّيد الخوئي (رحمه الله) يفتي بوجوبها لو لا معارضة السِّيرة العمليَّة؛ فقد قال في بيان مستند المسألة: "للنصِّ الوارد في المقام، وعمدَتُه صحيحة سليمان بن حفص المروزي؛ قال: ..." وذكرها، ثُمَّ قال: "وهذه الرواية ضعيفةٌ عند القوم؛ لعدم ثبوت وثاقة المروزي، ومن هنا حكموا بالاستحباب من باب التسامح، ولكنَّها مُعتبَرَةٌ عندنا، لورود الرجل في أسناد كامل الزيارات، وبما أ نَّها دلَّت على الوجوب صريحًا فمُقْتضى الصناعة الحكم به لا الاستحباب"، ثُمَّ إنَّه (رحمه الله) استدرك قائِلًا: "لكِنَّ الذي يمنعنا عنه هو ما تكرَّرت الإشارة إليه في مطاوي هذا الشرح حيثُ إنَّ المسألة كثيرة الدوران ومحلٍّ للابتلاء غالبًا، لعدم خلوِّ كُلِّ مُكلَّف عدا مَن شذَّ عن السفر، بل الأسفار العديدة، وفي مثله لو كان الوجوب ثابتًا لاشتهر وبان وشاع وذاع ولم يقع محلًّا للخلاف؛ كيف ولم يذهب إليه أحدٌ فِيمَا نعلم، والسِّيرة العَمَليَّة قائِمَةٌ على خلافه، فيكون ذلك كاشفًا قطعيًّا عن عدم الوجوب. ولأجله لا مناص من حمل الصحيحة على الاستحباب، وأنَّه يتأكَّدُ في حقِّ المسافر، لثبوت الاستحباب لغيره أيضًا من باب التعقيب كما أشار إليه في المتن"[9].
نُلاحِظ إرجاعه (رحمه الله) الحمل على الاستحباب لعدم ثبوت وثاقة المروزي، ثُمَّ جعل المرجع هو السِّيرة العمليَّة القائمة على خِلاف الوجوب، وعليه فلا تبعدُ صحَّةُ أن يُقال باستناد مبدأ السِّيرة العمليَّة إلى عدم ثبوت وثاقة المروزي، ولكنَّ هذا لا يفيد في النتيجة الَّتي انتهى إليها السَّيد الخوئي (رحمه الله) على فرض رجوعه عن القول بتوثيق رجال كامل الزيارات والالتزام باختصاص التوثيق بمشايخ مؤلِّفه الشَّيخ جعفر بن محمَّد بن قولويه القمِّي (رحمه الله)؛ ومستند هذا الفرض تصريح ولده السَّيد عبد الصَّاحب الخوئي (حفظه الله) في مقدِّمة الطبعة الخامسة من كتاب معجم رجال الحديث؛ حيث قال: "جرتْ تعديلاتٌ أساسيَّةٌ على الكتاب في بعض المباني الرجالية والأصول العامَّة المُتخذة في مقدمة المُعجم أدَّت إلى تغييرات جذرية على مواقع بعض رجال الحديث واعتباراتهم من حيثُ التوثيق والتضعيف، وعلى بعض طُرق الرواية من حيثُ الصحة والضعف شملت جميع أجزاء الكتاب، استنادًا إلى رجوع الإمام المؤلِّف عن توثيق رواة كتاب (كامل الزيارات لابن قولويه "قده")، وقد استدرك الإمام المؤلِّف ذلك بقوله: (فلا مناص مِنَ العُدُول عمَّا بينا[10] عليه سابقًا، والالتزام باختصاص التوثيق بمشايخه بلا واسطة)"[11].
ولكنَّنا لا نستقرب فَرْضَ استناد مبدأ السِّيرة العمليَّة إلى عدم ثبوت وثاقة المروزي؛ وذلك لوجهين:
أحدهما: أنَّ القول بالاستحباب جرت به أقلام أعلام فقهاء الأخباريين كما مرَّ، إلَّا أنْ يُقال باعتبارهم، أعني علماءنا الأخباريين، معارضة السِّيرة العمليَّة لخبر المروزي فقدَّموها عليه، مع التنبُّه إلى أنَّ انعقاد السِّيرة كان في عصور المعصومين (عليهم السَّلام).
ولا تغفل عن أنَّ (السِّيرة العمليَّة) ليست هي (الشهرة العمليَّة) الَّتي قيل بكونها قسيمًا للشهرتين الفتوائيَّة والروائيَّة؛ حيث إنَّ الشُّهرة العمليَّة تستند إلى نصٍّ يدلُّ على الحكم، وهي في الواقع شُهرة فتوائيَّة، فالصحيح هو تقسيم الفتوى تقسيمًا ثنائيًّا لا ثلاثيًّا.
والآخر: أنَّ الاعتبارَ ثابتٌ للسِّيرة العمليَّة فيما إذا كانت مُتَّصِلةً بعصر النَّص؛ بأنْ يكون عدمُ التزام الأصحاب بتسبيحة الجبر مِمَّا ورثه الفقهاء وعموم المؤمنين في زمن الغيبة، وكان هو المُؤثِّر في الانصِراف عن القول بالوجوب، أمَّا السِّيرة العمليَّة للفقهاء بعد الغيبة وعدم ثبوت اتِّصالها بسيرة المتشرِّعة في زمن النَّص فمحلُّ كلام بين الأعلام. وبالتَّالي وفي فرض الكلام فإنَّ السِّيرة المعتبرة قبل المروزي، والمتعيِّن حينها حملُ روايته على الاستحباب.
المتحصَّل: استناد القول باستحباب تسبيحة الجبر (في قبال القول بوجوبها) إلى السِّيرة العمليَّة الممتدَّة من عصر النَّص. إلَّا أنْ يَرِدَ ما ينفيها أو يزعزع استقرار القول بها. أمَّا عدم وثاقة المروزي فلا أثر له في القول بالاستحباب في قبال الوجوب.
الروايات في المقام:
1/ محمَّد بن الحسن الطوسي شيخ الطائفة، عن الحُسين بن عُبيد الله، عن أحمد بن محمَّد بن يحيى العطَّار، عن أبيه محمَّد بن يحيى، عن محمَّد بن علي بن محبوب، عن محمَّد بن عيسى العبدي، عن سليمان بن حفص المروزي، قال: "قال الفقيه العسكريُّ (عليه السَّلام): يَجِبُ عَلَى اَلْمُسَافِرِ أَنْ يَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ يُقَصِّرُ فِيهَا: سُبْحَانَ اَللَّهِ وَاَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاَثِينَ مَرَّةً؛ لِتَمَامِ اَلصَّلاَةِ"[12].
2/ محمَّد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق، قال: حدَّثنا تميم بن عبد الله بن تميم القرشي، قال: حدَّثني أبي، عن أحمد بن علي الأنصاري، قال: سمعت رجاء بن أبي الضحَّاك يقول: "بَعَثَنِي اَلْمَأْمُونُ فِي إِشْخَاصِ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنَ اَلْمَدِينَةِ ..." واخذ في وصف حال الإمام الرضا (عليه السَّلام) وما عليه من عبادة وذِكر وخضوع لله جلَّ في عُلاه، وكان مِمَّا قال: "وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ كُلِّ صَلاَةٍ يَقْصُرُهَا: سُبْحَانَ اَللَّهِ وَاَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَاَللَّهُ أَكْبَرُ ثَلاَثِينَ مَرَّةً، وَيَقُولُ: هَذَا تَمَامُ اَلصَّلاَةِ"[13].
والصارف عن الحمل على الوجوب والإلزام كما صرَّح الأعلام ثلاثة أمور:
الأوَّل: الشُّهرة الفتوائيَّة:
فهي معتبرة عند من تأخَّر عنها، فالفرض إذن قيامها أوَّلًا، ثُمَّ اعتبارها عند متأخرين عنها. والمستند فيها الروايتين، أمَّا القول بالاستحباب فلضعف الأولى بالمروزي، والثَّانية للمجاهيل، ولكنَّ المروزي مُوثَّق بالتوثيق العام لوروده في أسناد كامل الزيارات، والدلالة على الوجوب تامَّة، فإن قلنا بصحَّة السَّند كانت الشُّهرةُ كاسرةً عند من يقول بذلك. ويبقى الكلام في مُستند من اشتهرتْ الفتوى بِهم. فتأمَّل.
الثَّاني: ضعف سند الرواية الأولى بالمروزي. أمَّا الثَّانية فرواتها مجاهيل من تميم شيخ الصدوق إلى الأنصاري.
ذكرنا توثيق سليمان بن حفص المروزي بالتوثيق العام لوروده في أسناد كامل الزيارات، فهو ثقة عند من يقول بكفاية وردوه في أسناد كامل الزيارات، وهما موردان:
أحدهما: حدثني حكيم بن داوود، عن سلمة بن الخطَّاب، عن علي بن محمَّد، عن بعض أصحابه، عن سليمان بن حفص المروزي، عن الرجل، قال: "تَقُولُ عِنْدَ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اَللَّهِ فِي أَرْضِهِ ...".[14].
والآخر: حدثني حكيم بن داوود بن حكيم، عن سلمة بن الخطَّاب، عن الحسين بن زكريا، عن سليمان بن حفص المروزي، عن المبارك، قال: "تَقُولُ عِنْدَ قَبْرِ اَلْحُسَيْنِ (عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ) اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اَللَّهِ فِي أَرْضِهِ ..."[15]. مع اختلاف طفيف في المتن.
وقد روى عنه المحمدون الثَّلاثة في كتبهم الأربعة وغيرها.
فائدة: ابنُ الضحَّاك من رجال الدولة العبَّاسيَّة، وقد كلَّفه المأمون بإشخاص الإمام الرِّضا (عليه السَّلام) من المدينة المنوَّرة. والحقُّ أنَّ روايته لأحوال الإمام (عليه السَّلام) سالمة من أدنى ما يدعو إلى ريبة، بل على العكس من ذلك؛ حيث قال في مطلعها: "كُنْتُ مَعَهُ مِنَ اَلْمَدِينَةِ إِلَى مَرْوَ، فَوَ اَللَّهِ مَا رَأَيْتُ رَجُلًا كَانَ أَتْقَى لِلَّهِ تَعَالَى مِنْهُ، وَلاَ أَكْثَرَ ذِكْرًا لِلَّهِ فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِهِ مِنْهُ، وَلاَ أَشَدَّ خَوْفًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُ. وَكَانَ إِذَا أَصْبَحَ صَلَّى اَلْغَدَاةَ فَإِذَا سَلَّمَ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ يُسَبِّحُ اَللَّهَ وَيُحَمِّدُهُ، وَيُكَبِّرُهُ، وَيُهَلِّلُهُ، وَيُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ) حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَةً يَبْقَى فِيهَا حَتَّى يَتَعَالَى اَلنَّهَارُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى اَلنَّاسِ يُحَدِّثُهُمْ وَيَعِظُهُمْ إِلَى قُرْبِ اَلزَّوَالِ، ثُمَّ جَدَّدَ وُضُوءَهُ وَعَادَ إِلَى مُصَلاَّهُ، ..."، وذكر الكثير من التفاصيل في عبادة الإمام (عليه السَّلام) وليس فيها ما يُعارِض ما هو ثابت في الشَّريعة الغرَّاء، ثُمَّ إنَّ نقله للذِّكر بعد المقصورة موافِقٌ لرواية المروزي من جهتين؛ إحداهما التسبيحات الأربع، والأخرى كونها لتمام الصَّلاة.
الثَّالث: السِّيرة العمليَّة.
إذا ثبت استناد الشُّهرة الفتوائيَّة إلى سيرةٍ عمليَّةٍ مُتصِلةٍ بعصر النَّص فلا تَرَدُّد في النَّقضِ بها على دلالة الوجوب والإلزام؛ إذ لا شكَّ حينها في الانصراف إلى الاستحباب. والظاهر استناد قول الأعلام بالاتصال إلى قاعدة (لو كان لبان).
فنقول: إنَّ التسليم للقاعدة مُعلَّقٌ على إحراز عدم المانع أو الحاجب، ومع عدم إحرازه لا مناص من الرجوع إلى النَّص.
ثُمَّ نقول:
ولكنَّ الوجوب في رواية المروزي عُلِّل بإتمام الصَّلاة؛ فقد وردت (اللام) في قوله (عليه السَّلام): "لِتَمَامِ اَلصَّلاَةِ" مورد التعليل لقوله (عليه السَّلام): "يَجِبُ عَلَى اَلْمُسَافِرِ أَنْ يَقُولَ ..."، وقد قال أبو هلال العسكري: "الكمال: اسمٌ لاجْتِماعِ أبْعَاضِ المَوصُوفِ بهِ. والتَّمَامُ: اسْمٌ للجُزء الَّذي يتمُّ به الموصوف. ولهذا يقال: القافية تمام البيت، ولا يقال: كماله. ويقولون: البيت بكماله، أو باجتماعه"[16]. وقالوا بأنَّ التمام من قبيل تمام الخِلقة بوجه وعينين وأذنين وأنف ويدين ورجلين وصلب وبطن وصدر وبكلِّ ما ينفي النَّقص عن البدن، فالتمام ضد النَّقص، وإذا كانت تلك الأجزاء في درجة مُثلى من الاستواء والتناسق والجمال فذلك كمالها، فالتمام إذن لا يقتضي الكمال، ولذلك فإنَّ الله تعالى أكمل الدين، أي جعله من بعد تمامه في الدرجة المُثلى ولا يزاد فيه مطلقًا، وأتمَّ النِّعمة أي أعطى من النعم ما يحتاجه الإنسان، ولكنَّ الزيادة ممكنة[17].
ولا يُقال بترادف اللفظين في رواية أبي الحسن الثَّاني (عليه السَّلام) إذ قال في حديث له: "وَأَنْزَلَ فِي حَجَّةِ اَلْوَدَاعِ وَهِيَ آخِرُ عُمُرِهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ (اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلاٰمَ دِينًا)، وَأَمْرُ اَلْإِمَامَةِ مِنْ تَمَامِ اَلدِّينِ. وَلَمْ يَمْضِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ حَتَّى بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ مَعَالِمَ دِينِهِمْ وَأَوْضَحَ لَهُمْ سَبِيلَهُمْ وَتَرَكَهُمْ عَلَى قَصْدِ سَبِيلِ اَلْحَقِّ، وَأَقَامَ لَهُمْ عَلِيًّا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَمًا وَ إِمَامًا، وَمَا تَرَكَ لَهُمْ شَيْئًا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ اَلْأُمَّةُ إِلاَّ بَيَّنَهُ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُكْمِلْ دِينَهُ فَقَدْ رَدَّ كِتَابَ اَللَّهِ، وَمَنْ رَدَّ كِتَابَ اَللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِهِ"[18]؛ والوجه في ذلك أنَّ النِّعمة التامَّة في الآية الشَّريفة هي كلِّ الدِّين ومنه الإمامة، وأمَّا كماله فقد بيَّنه الله تعالى في الثِّقلين بِما جعل التمسُّك بهما عصمةً من الضَّلال.
ولا يُشكل بِما ورد عنهم (عليهم السَّلام) بوقوع النافلة (مُتمِّمة) للفريضة؛ كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر (عليه السَّلام)، قال: "إِذَا مَا أَدَّى اَلرَّجُلُ صَلاَةً وَاحِدَةً تَامَّةً قُبِلَتْ جَمِيعُ صَلاَتِهِ وَإِنْ كُنَّ غَيْرَ تَامَّاتٍ، وَإِنْ أَفْسَدَهَا كُلَّهَا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْهَا وَلَمْ يُحْسَبْ لَهُ نَافِلَةٌ وَلاَ فَرِيضَةٌ، وَإِنَّمَا تُقْبَلُ اَلنَّافِلَةُ بَعْدَ قَبُولِ اَلْفَرِيضَةِ، وَإِذَا لَمْ يُؤَدِّ اَلرَّجُلُ اَلْفَرِيضَةَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ اَلنَّافِلَةُ. وَإِنَّمَا جُعِلَتِ اَلنَّافِلَةُ لِيَتِمَّ بِهَا مَا أُفْسدَ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ"[19]. فالإتمام في الصحيحة عارِضٌ على نقص الإقبال في الصَّلاة، وهو أمر معنوي تسدُّ النافِلَةُ نقصه، ومعروض ما نحن فيه نقص في أجزاء الصَّلاة وهو الركعتان من الرباعية، فالنافلة تؤتى برجاء إتمام (النقص) في الإقبال، والتسبيحات الأربع يؤتى بها للإتمام (النقص) في الفريضة المقصورة.
وكيف كان؛ فقد يُستعمل الكمال محل التمام، والتمام محل الكلام، وإنَّما ذكرنا الفرق الوارد بينهما لتكرُّر الإتمام في الروايتين ومناسبته لِموضِع البحث كقرينة أو إشارة إلى الاعتبار الشَّرعي لذكر التسبيحات الأربع ثلاثين مرَّة في دُبُر الفريضة المقصورة.
إذا تمَّ ذلك فإنَّ الصَّلاة المقصورة ناقِصَةٌ وتمامُها بالتسبيحات الأربع يُؤتى بها ثلاثين مرَّة في دُبُرِها. والأوفق أن يُقال: تسبيحة الإتمام، لا الجبر. فتأمَّل.
وإن لم تقبله فيبقى التمسك بالنص على الوجوب مع عدم إحراز اتصال السِّيرة العمليَّة بزمن النَّص.
كما ولا يُشكل بكون التقصير هديةً من الله جلَّ في عُلاه إلى النبي الأكرم (صلَّى الله عليه وآله) وامَّته؛ فقد روى الصدوق (رحمه الله) بسنده عن السكوني، عن جعفر بن محمَّد، عن أبيه (عليهما السَّلام)، قال: قال رسول الله (صلَّى الله عليه وآله): "إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَهْدَى إِلَيَّ وَإِلَى أُمَّتِي هَدِيَّةً لَمْ يُهْدِهَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ اَلْأُمَمِ كَرَامَةً مِنَ اَللَّهِ لَنَا. قَالُوا: وَمَا ذَلِكَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ؟ قَالَ: اَلْإِفْطَارُ فِي اَلسَّفَرِ وَاَلتَّقْصِيرُ فِي اَلصَّلاَةِ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ رَدَّ عَلَى اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هَدِيَّتَهُ"[20]. من جهة عدم مناسبة فرض الإتمام بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرَّة وكون القصر هديَّةً منه تبارك ذكره.
فالإشكال يتوجَّه فيما لو أهدانا سبحانه التقصير وفَرَضَ علينا ركعةً منفصلةً أو اثنتين، ولا يرد على الإلزام بالتسبيحات؛ وكونها أخفَّ مُستغن عن البيان. ثُمَّ لو تمَّ الإشكال لتوجَّه إلى التسبيحات حتَّى على فرض استحبابها!
وناسب أن يقعَ الكلامُ الآن في: جِهَةُ المِلاك:
لا شكَّ في أنَّ مِلاكات الأحكام الشرعيَّة مجهولةٌ للعِباد ما لم يكشف عنها النَّصُّ الشَّريف، وإنَّما يُقال باستيفاء المِلاك بإتيان المأمور به على وجهه، ومن تمام الوجه الشرعي إيقاع العَصْرَين والعِشاء الآخرة أربعًا.
فإمَّا أن يُقال ببقاء المِلاك مع قصر الصَّلاة في السَّفر، أو بتغيره ووقع القصر موافقًا له، وعلى الأوَّل فالصَّلاة المقصورة غير تامَّة قياسًا على المِلاك، لا على الأربع في الحضر. فتنبَّه. وعلى الثَّاني تامَّة وتكون التسبيحات الأربع عقيبها جهةَ كمالٍ لها وليست جهة تمام.
فنقول: إذا تولَّد شَكُّ عِلميٌّ مُعتَبرٌ في استيفاء المِلاك وجب الاحتياط بإتيان التسبيحات الأربع ثلاثين مرَّة في دبر الصَّلاة المقصورة؛ إذ المورد مورد فتوى بالاحتياط للشَّكِّ فيما يُخرِج من التكليف.
المُتحصَّل: لا يُطمأنُّ لكون السِّيرة العمليَّة منعقدةً في زمن النَّصِّ وامتدادها لِما بعد وقوع القضاء بغيبة الإمام (عليه السَّلام)، بل قد تكون شهرةً على خِلاف مُفاد (يجب) في قوله (عليه السَّلام): " يَجِبُ عَلَى اَلْمُسَافِرِ أَنْ يَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ يُقَصِّرُ فِيهَا: ..."، ولا نعلم بمبدأ انعقادها.
الأقرب هو الفتوى بالوجوب لمفاد (يجب) وظهور (الإتمام) في سدِّ النَّقص، أو الفتوى بالاحتياط للخروج من عهدة التكليف بعد الشكِّ فيه.
يبقى الكلام في أمرين:
أحدهما: محلُّ تسبيحة الإتمام:
في رواية المروزي قال: "فِي دُبُرِ ..."، فيما قال ابنُ الضحاك: "وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ كُلِّ صَلاَةٍ يَقْصُرُهَا ..."، ولا دلالة للعبارتين على وجوب إيقاع التسبيحة عقيب التسليمة الأخيرة في الصلاة دون فاصل ولا حتَّى بتكبيرات التعقيب الثَّلاث، ولكنَّه بناء على كونها متمِّمَة للصَّلاة فالأنسب أن يؤتى بها بعد الفريضة المقصورة دون فاصل، وهو الموافق للاحتياط؛ فتتمّ الصَّلاة ويُعقَّب بعدها بالتعقيبات المأثورة.
والآخر: حكم من لم يأتِ بتسبيحة الإتمام:
الحكم بالقضاء عند من يقول بأنَّ القضاءَ تابعٌ للوجوب ولا يحتاج إلى خطاب ينصُّ عليه، ولا قضاء عند من يقول بافتقار القضاء إلى خطاب ينصُّ عليه، وهذا الأخير هو الأوفق للأصول. والحال حينذاك الإجزاء دون الوفاء بالملاك، وعدم القدرة على الاستدراك.
والله العاصم من الضلال وهو المُسدِّد للصواب، أسأله سبحانه وتعالى رضاه والعافية.
السَّيد محمَّد بن السَّيد علي العلوي
17 من رجب 1446 للهجرة
البحرين المحروسة
...............................
[1] - مقتبس من كتاب: المزارات في البحرين -الشَّيخ محمَّد باقر النَّاصري- ص108.
[2] - قال: مفتاح (مستحبات حالة التعقيب): "يُستحبُّ أن يكون جلوسه في التعقيب كجلوسه في التشهد متورِّكًا، ..." إلى أن قال عاطِفًا على الاستحباب: "وأن يُسبِّح بالتسبيحات الأربع عقيب كلِّ فريضة مقصورة ثلاثين مرَّة جبرًا لقصرها؛ كما في الخبر". (مفاتيح الشرايع – الفيض الكاشاني- المفتاح 177، ج1 ص162).
[3] - الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشَّرايع -الشَّيخ حسين آل عصفور البحراني- (مخطوط).
[4] - كتاب من لا يحضره الفقيه -الشَّيخ الصدوق- ج1 ص453.
[5] - وسائل الشِّيعة -الحرُّ العاملي- ج8 ص523.
[6] - الحدائق الناضرة – الشَّيخ يوسف آل عصفور البحراني- ج11 ص488.
[7] - مرآة الأخبار في أحكام الأسفار -الشَّيخ محمَّد آل عصفور البحراني- ج3 ص55.
[8] - مُعتَمَد السَّائل -الشَّيخ عبد الله السِّتري- ج1 ص109.
[9] - قال سيد العروة: "مسألة 15: يستحبُّ أن يقول عقيب كلِّ صلاة مقصورة ثلاثين مرَّة: (سـبحان الله والحمد لله ولا إله إلَّا الله والله أكبر، وهذا وإن كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كلِّ فريضة حتَّى غير المقصـورة إلَّا أ نَّه يتأكَّد عقيب المقصورات، بل الأولى تكرارها مرَّتين؛ مرَّة من باب التعقيب ومرَّة من حيثُ بدليتها عن الركعتين الساقطتين"
[10] - الأقرب أنَّه أراد: (بنينا) وليس: (بينا).
[11] - معجم رجال الحديث -السَّيد الخوئي- مقدِّمة الطبعة الخامسة ص23.
[12] - تهذيب الأحكام -الشَّيخ الطوسي- ج3 ص230.
[13] - عيون أخبار الرِّضا (عليه السَّلام) -الشَّيخ الصدوق- ج2 ص180.
[14] - كامل الزيارات – ابن قولويه- ص209.
[15] - نفس المصدر، ص210.
[16] - الفروق اللغوية -أبو هلال العسكري- ص15.
[17] - من لقاء تلفزيوني مع الدكتور فاضل السَّامرائي.
[18] - الكافي -الشَّيخ الكليني- ج1 ص198.
[19] - الكافي -الشَّيخ الكيني- ج3 ص269.
[20] - علل الشرائع -الشَّيخ الصدوق- ج2 ص382.