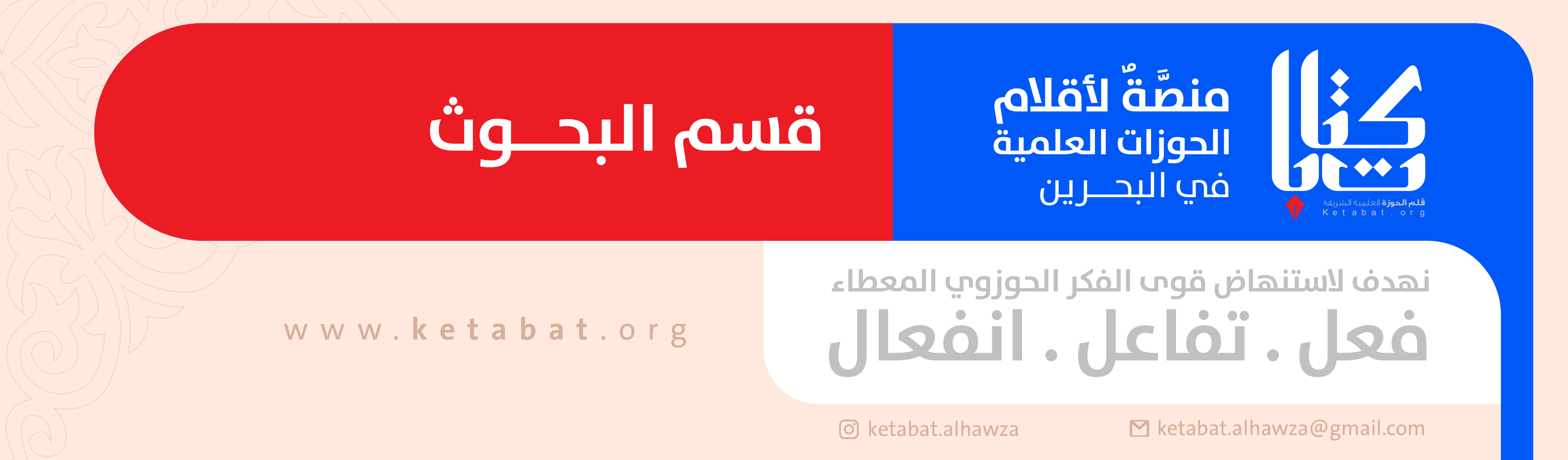
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:
عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): جعل الله سبحانه مكارم الأخلاق صلة بينه وبين عباده، فَحَسْبُ أحدِكم أن يتمسك بخُلُقٍ متصل بالله.
تنبيه الخواطر: 2 / 122.
إن للأخلاق الدورَ المُهَيمِنَ في مضمارِ الحياة، من حيثُ إعمارُ الحياةِ وصيانتُها من كل ما يُشقيها ويُرهِقُها، والسيرُ بهذه الحياة إلى الأكملِ والأفضل، ولأنَّ للأخلاقِ كلَّ هذه الأهمية والجاذبية، ولتأثيرها على كافة جوانب الحياة، ولارتباطها بكل موجودٍ في هذا الكون؛ صارت محلَّ بحثٍ ومثارَ جدلٍ بين العلماء والباحثين والمفكرين، وتَكوَّنَت على إثرها المدارسُ وتنوعتِ المسالكُ وتعددتِ الأفهام، فنجد أنفسنا أمام إشكالياتٍ محورية تدور حول العلاقة بين الأخلاق والدين، حيثُ وقع الصراع الفكريُّ والعَقَدِيُّ حولها، حينَ ذهب بعضهم إلى أن الأخلاقَ متكئةٌ على الدين ومُستَلَّةٌ في كثير من تفصيلاتها منه حتى ولو كانت هناك بديهياتٌ وثوابتُ مُستفادةٌ من حُكمِ العقل، وذهب غيرهم إلى أنها ليست ناشئة إلا من الأسباب العقلائية وعلى أساس التجارب الإنسانية، ولا حاجة للدين من أجل تأطيرها ولا من أجل فهمها ولا من أجل معرفة تفصيلاتها، وذهب آخرون إلى أن المعيار في تحديد الأخلاق إنما يكون بإحساسات الروح وسمواتها، فيكون هذا الحس كاشفًا عن القيمة الأخلاقية التي التذت بها الروح وتسامت، سواء وُجِدَ دينٌ أم لا وسواء قَبِلَ العقلُ أم لا.
فاستدعى كل هذا النزاع المحتدم منا أن نتناول القضية بشكلٍ موضوعي حسبما نراه، وأن نعمل على محاولة تحصيلِ فهمٍ عميق له، والبحثِ من أجل الكتابة فيه كتابةً تتناول حيثياتِه بشكل رصينٍ ومُتقَن، يؤدي إلى نتيجة مرضية ونافعة للأجيال، جُهدٌ بذلناه بعنايةٍ إدراكًا منا إلى الحاجة الملحة للتعاطي مع هذه القضايا الدائرة بين المجتمعات المعاصرة هذا اليوم، حيث تواجهُ الأجيال القادمة مسائل صعبة وتحديات شاقة، ولابد لنا من أن نُعالجها ونعمل على تحصين الفكر وتصحيحه حفاظًا على سلامة الفطرة والفكر لهذه الأجيال.
الموضوع:
وحيثُ إنَّ موضوعنا يتناول الأخلاقَ والقيمَ الأخلاقية، وما إذا كان للدين دخالةٌ في شؤونها، فإنه يجدر بنا أولًا أن نُعَرِّفَها لغةً ثم نُعَرِّجَ على تعريفها اصطلاحا.
التعريف لغة:
الأخلاق هي جَمعٌ مفرده الخُلُق، والخُلُقُ يطلق على الطبع والسجية والمروءة والدين.
وحقيقته أنه وصف لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها، بمنزلة الخَلْق لصورته الظاهرة، وأوصافها ومعانيها ولهما أوصاف حسنة وقبيحة.
(القاموس المحيط للفيروز أبادي ولسان العرب لابن منظور)
يقال: فلانٌ حسن الخُلُقِ والخَلْق؛ أي حسن الباطن والظاهر، فيراد بالخَلق الصورة الظاهرة وبالخُلُق الصورة الباطنة.
التعريف اصطلاحًا:
أما اصطلاحًا فأجدُ أنَّ أفضلَ ما يُمكنني تعريفُها به هو أنَّ القيمَ الأخلاقية:
هي مفاهيمُ نَظريةٌ يختارها الإنسان على أساس ما ينبغي وما لا ينبغي – سواءٌ كان يرى ما ينبغي وما لا ينبغي على مستوى العقل أم الدين أم إحساسات الروح التي أسلفنا ذكرها- فتُضفِي هذه المفاهيمُ عليه صفاتٍ -كالأمانة وضدها الخيانة-، تَنتُج عن هذه الصفاتِ أنحاءُ سلوكه وتصرفاته العملية -كحفظ الأمانة وضدها تضييعها أو استغلالها بصورةٍ ما-، ومن المفترَض أن تكون هذه الصفاتُ الناتجةُ عن مفاهيمه صفاتٍ حميدةً لا خبيثةً وصحيحةً لا سقيمة؛ لأنه يريد من خلال سلوكه تحسينَ ذاته عند نفسه وعند الغير؛ حبًا منه لبلوغ حالة المثالية والتكامل حتى ولو كانا مجردَ مثاليةٍ وتكاملٍ ظاهريين لا واقعيين.
الفرق بين القيم الأخلاقية وسائر القِيَم:
يُقابل القيم الأخلاقية قِيَمٌ اجتماعية وقِيَمٌ ثقافية تحتكُ عادةً بالقيم الأخلاقية فتثير جدلًا واسعا، ولكن هذا في الواقع بسبب تشتت المناهج والمذاهب والمشارب المتولدةِ إما من أهواء الأنفس أو من تفاوت العقول وقصوراتِها، وتقلبها ما بين كفتي الإفراط والتفريط، ما يوحي لنا بالحاجة الماسة إلى منهجٍ شاملٍ ودستورٍ كامل، يحيطُ الروحَ لمعالجة الهوى، ويحيطُ العقلَ لمعالجة التفاوت بين العقول وقصوراتها، منهجٌ لا تعبث فيه أيادي العابثين كما وقع على المناهج السابقةِ من مغالطاتٍ وتضليل وتحريفٍ وتزييف، وهذا يقتضي أن يكون حَمَلَتُهُ في حصانة من الوقوع في الخطأ والاشتباه، لا تَحرِفُهُم زلة أو عثرة، ولا غفلة أو هفوة، صانَهم موجِدُهم عن الخطايا، وآتاهم علوم المنايا والبلايا، خلفاءُ لله في أرضه، وأُمناؤه على دينه، حيث إنَّ كلَّ صانعٍ يَصنَعُ صنعةً -كصانع السيارة مثلًا-، يكون له دليل إرشادي لبيان ما لها وما عليها، فيه تعاليمُ يُرجَع إليها عند الحَيْرَةِ والتَّلَتُه، ولا شك أن لصانع هذا الكون المُحكَمِ في صنعه دليلٌ تفصيلي كذلك، يُعالِجُ دقائقَ الأمور في مختلَف الحقول، ويُرجَع له عند الحيرة والضياع والاختلاف وتفاوت العقول وتضارب الأفكار والآراء، وهو مقتضى حكمته.
والواقع أن هذا المنهج الذي هو طريق الموازنة مابين هذه القيم الثلاث إنما هو كامِنٌ في بوتقةِ الإسلام، حيثُ فيه تُغَربَلُ الأفكار، وتُهَمَّشُ الأهواء، وتُمَحَّصُ الآراء، على مباني العقل والكتاب والسنة، فينتج من بوتقة الإسلام مزيج يَحُدُّ بحدوده القيم الثلاث لِيَشمَلَ أفرادَها، ويُخرِجَ أغيارَها، فتكونُ منسجمةً فيما بينها ومتناسقة مع بعضها.
أما القيم الاجتماعية فهي ما نُعبِّرُ عنهُ عادةً بـ"العُرف العامِّ في المجتمع الفلاني"، وهذه القِيَم الاجتماعية كثيرًا ما تحتكُ بالقيم الأخلاقية، فقد يكونُ من المعيب القيامُ بسلوكٍ ما عند مجتمعٍ ما في عرفه العام، ولكنه ليس إلا لِما جَرَت عليه العادة والتقاليد في ذلك المجتمع، وليس لأن السلوك صدر من سالكه لصفاتٍ خبيثةٍ ورذائلَ في نفسه، وإنما غايةُ الأمرِ أن المجتمع لا يقبل ذلك السلوك، ولو لم يكن من رذائل الأخلاق، وقد يكونُ العكس فيكون الأمر غيرُ الأخلاقيِّ أمرًا من المعيب تركُه في العرف العامِّ للمجتمع الفلاني، بل وتُوجَّه لك التوبيخات وتتم مخاصمتك وإقصاؤك من المجتمع، ولابد لك أن تأتي به "كمعانقة جارتك الأجنبية عند عودتها من السفر مثلًا"، ومن هنا تأتي الحاجة للدين لِيضبطَ المجتمعَ وأعرافَه في مثل هذه الموارد وأعم وأغلب المسائل.
وأما القيم الثقافية فهي موروثٌ هائلٌ ناشئ من مراحلَ عديدةٍ على مرِّ العصور، أثَّرَ في ذلك كلِّه التاريخُ والتراثُ وآثارُ الأولينَ وحتى ما تَجَدَّدَ في العصور الحديثة من الفنون والأدب والموسيقى وغيرها، ما يستدعي تصادمًا شديدًا فيما بين القيم الثقافية والقيم الأخلاقية والقيم الاجتماعية، ولا يُصلِحُ ذلك إلا الإسلامُ الحقُ كما أوضحنا سالفا.
تأثير القيم الأخلاقية وأهميتها:
لابد لنا من استيعابِ أهمية القيمِ الأخلاقية في الحياة على جميع مستوياتها؛ حتى يكونَ عندنا الباعث والدافع والحافز نحو البحث في هل أن هناكَ حاجة إلى الدين لتحديد هذه القيم وضبطها ضبطًا سليمًا دقيقًا أم لا؟
ومبدئيًا نقول أنه يكفي أنْ نعلمَ للوَهلة الأولى بأنَّ للقيم الأخلاقية أهمية على المستوى الفردي والأسري والاجتماعي، حتى نَحكُمَ بَعدَها بوجوبِ الانبعاثِ نحو التحقيق في الحاجةِ إلى الدينِ من عدمها لضبطِ القيم الأخلاقية، فأيُّ شيءٍ يا تُرى أهمُّ عند الفرد من الفرد نفسه؟ وأيُّ شيءٍّ عنده يأتي أهمَّ من أسرته؟ وأيُّ شيءٍ أهمُّ من المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه هو وأبناؤه؟ فهذه المستوياتُ لها أولويةٌ قصوى عند كل إنسانٍ على وجه الأرض.
كانَ هذا تِبيانًا أوليًا لأهمية هذه القيم، حيثُ اتضحت أهميتها بملازمتها المصلحة الفردية والأسرية والاجتماعية للإنسان، وأما على نحو التفصيل فإنَّ أهميتها تتضحُ أكثرَ مِن خِلال بيانِ فوائدها التي سنأتي على ذكرها، والتي تَدلُّ على الحاجة الماسة للقيم الأخلاقية، وهذه الحاجة للقِيَم تدعو إلى طَلَبِ الإجابة عن هل أن للدين حاجةً في ضبط القيم سواءٌ على مستوى التأسيس أم على مستوى التأكيد؟
فوائد وثمار امتلاك القيم الأخلاقية الصائبة:
أ. تحقيق النضج وتقويم السلوك، وتوحيد الصفوف
إنَّ امتلاكَ مفاهيمَ تُضفي صفاتٍ تُنتِجُ سيرًا وسلوكًا لَهُوَ أمرٌ يساعِد على التصرف بطريقة يتحصل بها الوضوحُ والصورةُ الناصعةُ للقضايا، وتتحصلُ بها رؤيةٌ كونيةٌ غايةٌ في الرُّشْدِ والروعة، وهذا يُؤَدِّي إلى التعاملِ مع الأمور بِنُضْجٍ ووَعيٍ وبصيرةٍ وفِطنةٍ وفَهْم، النُضْجُ الذي يُساعِدُ على اقتناصِ قراراتٍ صائبة، وانتهاجِ سلوكٍ قويمٍ وسليم، وفاعليةٍ إيجابية مع ردودِ فعلٍ إيجابية، مِمَّا يُسهِمُ في حلِّ كثيرٍ من النزاعات والصراعات والتعاطي بِحِرَفِيَّةٍ مع التحديات المعقدةِ والصعبة، والتحلي بلياقة الروح الرياضية المُحلَّاةِ بسعةِ الصدر والتفهم والتسامح والتوقير والاحترام، وكلُّ ذلك يَعُود فَضْلُهُ إلى تأطيرنا لإطارٍ يحتوي في ضمنه مجموعةً فريدةً للقيم الأخلاقية.
ب. التماسك النفسي والاتزان الروحي، والنهوض بالأمة
إنَّ القلوبَ لَتَهوِي إلى النفوس الوقورةِ، المطمئنةِ، الفاضلةِ، والمبارَكةِ أينما كانت، والمحاطةِ بهالةِ الكاريزما أينما حَلَّت، هذه النفوسُ لا تهوي لها القلوبُ إلّا لِما تتحلَّى به من مَكارِمِ الأخلاق، وهي نفوسٌ أجادت في تشخيص معالمِ القيم الأخلاقيةِ الحقيقية، وبذلك تَكُونُ مُتماسِكةً متزِنة، وذاتَ علاقاتٍ صحيةٍ كما ينبغي، وبالسيرِ بسيرتها يَسرِي التماسكُ والاتزانُ على المستوى الشخصيِّ إلى تماسكٍ واتزانٍ على مستوى المجتمعِ وأفرادِهِ قاطِبة، مِن حيثُ الدعمُ والمؤاخاةُ والتطويرُ والتقدُّمُ والإعانةُ والتفاهمُ والإعمارُ والإنجاز، على جميع المستوياتِ الاقتصاديةِ والطبيةِ والتكنولوجيةِ والسياسيةِ والهندسيةِ واللوجستيةِ وغيرِها.
ج. الحفاظ على الأصالة والهوية والانتماء
ونَعني بها تِلكَ التي تَستحِقُّ من المرء أن يَعتَزَّ بها، التي تَستَمِدُّ نقاءَها وطُهرَها وفَخرَها من جَبهة الحق، ولَمْ يُلَوِّثْ صفحاتِ تاريخِها عارُ الباطل، هذه الأصالةُ والهويةُ والانتماءُ تدعونا قِيَمُنا الأخلاقيةُ إلى حِفْظِها وصِيانتِها من الضياع، فعلى المستوى الشخصي سَيَعِي صاحبُ القِيَم دورَه وموقعيتَه في هذا العالم، وعلى المستوى الاجتماعي سيَتِم الحفاظُ على كلِّ معروفٍ، ونَبْذِ كلِّ مُنكَر، في مجتمَعٍ يسوده عدلٌ وتَعمُّهُ فِطرةٌ سليمة، وينتشر فيه صِدقٌ وأمانةٌ وتعاطفٌ وسائرُ الفضائل، أما من لم يَضبِطْ إعداداتِ القيمِ الأخلاقيةِ في ذاتِه؛ فإنَّه يَنجَرِفُ مع كُلِّ سَيْلٍ جارِف، ويَنغَمِسُ في مستنقَع الخبائث، ولا شكَّ حينَها أنَّه في ظل هذه التحديات يَتوجب علينا البحثُ بجديةٍ في مسألةِ دخالةِ الدينِ في ضبطِ القيمِ الأخلاقيةِ والحاجةِ له من عدمِها.
د. امتلاك حس المسؤولية
حيثُ إنَّ صاحبَ القيمِ والمبادئ الحقةِ يسعى دائمًا إلى المبادرة قَبْلَ أنْ يُطلَبَ منه، وأوضحُ مصاديقِ ذلك تتجلى في حب المشاركةِ في فعل الخيرِ والتطوعِ ومساعدةِ المحتاجين، هذا النوعُ من الأشخاص له إنتاجيةٌ عاليةٌ ونجاحٌ باهر، يؤولُ على المستوى بعيدِ المدى إلى صلاح البشريةِ كلِّها.
ما المعيارُ الذي يُحدّدُ القيمَ الأخلاقيةَ؟
تَكَوَّنَت في هذا الصَّدَدِ ثلاثُ مدارسَ لتحديد المعيارِ الذي تبتني عليه القيمُ الأخلاقيةُ:
مدرسة الفلاسفة: وهي مدرسةٌ تعتمد في تنظيرها على البُعدِ الاجتماعي؛ حيثُ يرونَ أنَّ المِعيارَ في تحديد القِيَمِ هو ما يَصُبُّ في حفظ النظامِ العامِّ للمجتمع من الاختلال؛ لأن البشريةَ تعاقدتْ وتبانتْ منذُ أولِ يومٍ لها على مجموعةِ قيمٍ أخلاقيةٍ كي يحفظوا بها نظامَ العيشِ.
والمُلاحظُ على هذا المبنى: إنه يعني أنه سيتِم إقصاءُ وإخراجُ عَدَدٍ من القِيَم بسبب أنه لا مدخليةَ أو دورَ لها في حفظ النظام، بل ويصلُ الأمرُ إلى عَدِّ أمورٍ ضِمنَ القيم الأخلاقية وهي في الواقع خادِشةٌ تمامَ الخدشِ للأخلاق، كلُّ ذلك تحتَ عُنوانِ حفظِ النظام، فمثلًا نرى ما وصلوا إليه اليومَ من نشرِ الأوبئةِ بينَ فترةٍ وأخرى -خصوصًا في الصين التي يَجتاحُ سُكانُها العالمَ لكثرةِ أعدادِهِم-، ومن قَطْعِ النسلِ بإشاعة أفكارٍ ومفاهيمَ لتعزيز الممارسات الجنسيةِ والصداقاتِ دونَ الحاجةِ للزواج، ومن تشريع العلاقاتِ المِثْليةِ بين امرأةٍ وامرأةٍ أو رَجُلٍ ورَجُل، ومن تشريع العلاقاتِ مع الحيوانات، كلُّ ذلك بِحُجَّةِ أنَّ تِعدادَ السُّكّانِ على كوكب الأرضِ بَلَغَ حدًّا من الكَثرة تُهَدِّدُ استمرارَ الحياةِ على هذا الكوكبِ في المائتي سنةٍ القادمةِ -بِحَسَبِ دعواهم- ما يقتضي العملَ طِبقَ هذه القِيَم الإجراميةِ على أنها قيمٌ أخلاقيةٌ لأجل حفظِ النظام!
مدرسة علماء الأخلاق: وهي مدرسةٌ تُلاحِظُ البُعدَ الروحي؛ فكلُّ ما له لَذةٌ روحية، يشعرُ من خِلالها الإنسانُ بسموِ النفسِ وعُلوها، وأنَّ له نفسًا نبيلة؛ فهو داخلٌ ضمن القيمِ الأخلاقية، حيث إن في الأخلاق سموًا ورُفعة.
والمُلاحظ على هذا المبنى: إن الإحساسَ باللذة الروحيةِ قد يَختلِف وقد يَتَخلَّف، ففي مقارعة الظالمِ الذي يودُّ أنْ يغصِبني مُلكًا من أملاكي مثلًا قد يرى أغلبُ الناسِ أنَّ مقارَعَتَهُ مهلكةٌ وفيها إذلالٌ للنفس أمامَ الظالمِ إذا قاومتَه وليس سموًا، وأنَّ الأولى حفظُ النفسِ والمال، بينما يرى الباقونَ أنَّ في التضحية وافتداءِ النفسِ سموًا ورُفعة، كذلك في موقفٍ ما وتحت ظرفٍ ما "كالجهاد الابتدائي في هذا الزمان مثلًا" قد يرى عديدٌ من الناس أنه لا يجوز، وأنه ليس في ذلك سموٌ أبدا، ويرى آخرونَ خِلافَ رأيِهِم وأنَّ مَن فَعَلَها فَقَدْ جَنَى على نفسه وليس بشهيد؛ فيتضح أنه ليس للإحساس باللذة الروحيةِ مدخليةٌ لتحديد القيمِ الأخلاقية، وإنما هي أثرٌ من الآثار لنسبة كبيرةٍ من هذه القيم.
مدرسة المتكلمين: وهي مدرسةُ علماءِ الفكرِ الإسلامي، الذين قالوا بأن المعيارَ هو في الجمال والحسنِ الذاتيين، فالعدل مثلًا هو جميل وحسنٌ بذاته، ولجماله وحسنِهِ الذاتي يَحكُم العقلُ بأنه قيمةٌ من القيم الأخلاقيةِ وينبغي العملُ بها، وهو لِجمالِهِ يحفظُ النظامَ ولِجَمالِهِ يُشعِرُ بالسموِّ واللَّذةِ الروحية، فهي قضيةٌ بديهيةٌ لا تحتاجُ إلى سببٍ كي نَعُدَّ العدلَ -مثلا- قيمةً أخلاقيةً من خِلال القولِ بحفظ النظامِ أو باللذة الروحية، بل يكفي أنه جميلٌ وحسنٌ بذاته، وبديهيٌ أنَّ كلَّ جميلٍ وحسنٍ هو قيمةٌ من القيم.
ويلاحظ في هذا المبنى: إن معيارَها أكثرُ ضبطًا وإتقانًا وشمولا، فيرسو تحقيقنا على هذا المسلكِ، وهو الصحيح عندنا.
ما المنابعُ التي يَستخلِصُ منها الإنسانُ مفاهيمَهُ وتبتني عليها قيمُهُ الأخلاقيةُ؟
قد تكونُ المنابعُ كثيرةً ونُفَوِّتُ بعضَها أو لا نلتفتُ إليه، إلا أنَّ أبرزَ المصادرِ التي تتشَكَّل منها مجموعةُ مفاهيمِ الإنسانِ غالبًا ما تكونُ:
أ. البيئةُ الأسريةُ التي عاشَ فيها وأطباعُ ذويه وتربيتُهم وتعليمُهم له.
ب. تجربتُه الشخصيةُ في الحياةِ العمليةِ خارجَ المنزلِ سواءً مع أصدقائِه أم مع غيرهم.
ج. المناهجُ التعليميةُ في مدرستِه.
د. القوانينُ التي تُحيطُ به في دولتِه وكذلك في مكان وظيفتِه.
هـ. العاداتُ والتقاليدُ والعِرقُ والثقافةُ التي ينتمي إليها.
و. الدينُ أوِ اْلطائفةُ اللادينية التي قد ينتمي إليها وتمتلكُ فلسفةً حياتيةً خاصةً بها.
وبَعْدَ ذِكرِ هذه المنابعِ يَتضِح للقارئ العزيزِ كيفَ أنَّ القيمَ الأخلاقيةَ حينَها ستكون عشوائيةً متذبذبةً بتذبذبِ الأزمانِ والأماكنِ والبيئاتِ والتجاربِ والدُوَلِ والقوانينِ والعاداتِ والتقاليدِ والأديان، ما يَجعَل تحديدَ ما هو قيمةٌ أخلاقيةٌ مما ليس قيمةً أخلاقيةً أمرًا مُشكِلًا غايةَ الإشكال، ولا يتبقى حلٌّ سِوى التنقيبِ والبحثِ عن المصدر الأصيلِ والعِلْمِ الحقيقيِّ والدينِ الواقعيِّ الذي يُمَثِّلُ الدليلَ الإرشاديَّ لصانعِ هذا الصُّنْعِ البديعِ وخالقِ هذا الكونِ الكبيرِ، ومِنْ هُنا تتجلَّى لنا حقيقةُ أنَّ للدين دخالةً رئيسةً في الأخلاق، وأنَّ العقلَ والتجاربَ والبيئةَ والعاداتِ والتقاليدَ ليست كافيةً لتحديد القيم، كما أنَّها في كثيرٍ مِنَ اْلأحيانِ تُخِلُّ بالقيم الأخلاقيةِ وتتصادم معها.
وجوه الحاجةِ إلى الدين، وعدمُ إمكانِ فصلِهِ عن القيمِ الأخلاقية:
بَعْدَ أنْ أثبتنا أنَّ الدينَ هو الحلُّ في مُعضِلاتِ الأمورِ حينَ تتصادمُ القيمُ التي يَحمِلُها الناسُ فيما بينها نتيجةَ اختلافِهِم، نُؤكدُ مُجددًا على أنَّ الدينَ حاجةٌ ولا يُمْكِنُ فصلُه؛ لأنَّه الضمانةُ الوحيدةُ للحفاظ على القيم الأخلاقيةِ وتأكيدِها، فَضْلًا عن تأسيسِها وإقامةِ مشروعٍ حقيقيٍّ يحتوي مجموعةً شاملةً لهذه القيمِ الأخلاقيةِ الصائبة؛ وذلك لعدة أمور:
الأمر الأول: الدافعُ والرادع.
إنَّ استشعارَ الرقابةِ الإلهيةِ، والإيمانَ بالثواب والعقاب، واستراتيجيةَ الترهيبِ والترغيب، ناجعةٌ في ضمان التزامِ الإنسانِ بهذه القيم، فهي تدفعه للتحلي بالصفات الحميدةِ والسلوكياتِ الحسنة، وتَردَعُهُ عن الصفات الخبيثةِ والسلوكياتِ السيئة، وإلا فما الذي سَيَجْعَلُ الشخصَ مُلتَزِمًا بهذه القيمِ إذا تضاربت مع مَصالِحِهِ الشخصيةِ وأهوائِه؟
الأمر الثاني: الحاجةُ إلى دستورٍ يعملُ على تشخيصِ القيمِ في مواردِها المعقدة.
العقلُ عندَهُ قضايا كليةٌ معلومةٌ عند الجميعِ، مِنْ قَبِيلِ أنَّ الظلمَ قبيحٌ والعدلَ حسنٌ، ولكنْ في كثيرٍ مِنَ اْلموارد، يتعذرُ على العقلِ تحديدُ الموقفِ الذي تقتضيهِ الحالةُ، فمثلًا لو كانت عندك زوجةٌ حاملٌ بابنٍ لك، ووصلَتْ إلى مرحلةٍ قال الأطباءُ فيها أنه لابد من التضحية بأحدهما، فإمّا أنْ تموتَ الأمُّ أو أنْ يموتَ الإبن، فما هي القيمةُ الأخلاقيةُ التي ستتعاملُ بها في مثل هذا الموقف؟
قَد تَسُنُّ دُوَلٌ في هذا الصددِ قانونًا بقتل النساءِ حفاظًا على حياة الجنين؛ لِكَوْنِ نِسبَةِ كِبارِ السنِّ في ذلك البلدِ طاغيةً على المجتمع، ويُريدونَ أجيالًا جديدةً وشبابًا كُثُر حفاظًا على شعبهم وعِرْقِهِم، وقد تَسُنُّ دولٌ أخرى عكسَ ذلك تمامًا لأسبابٍ ترتأيها، أو قد لا يكونُ هنالك قانونٌ في هذا الشأنِ فيَختارُ بعضُ الرجالِ قتلَ زوجاتِهم، ويَختارُ بعضُهُمُ اْلآخرُ قتلَ أبنائِهِم، فما القيمُ الأخلاقيةُ الصائبةُ التي ينبغي التعاملُ بها حينَها؟
فَمِنْ هاهُنا تتضحُ الحاجةُ الماسةُ والدَّخالَةُ الرَّئيسَةُ للدين في تحديد وتأسيسِ وتأكيدِ القيمِ الأخلاقية.
الأمر الثالث: القدوةُ والأسوة
إذا كان مَنْ أتأسى به شخصًا مثاليًا مُتَسامِيًا في درجات التكاملِ ويُمْكِنُ التعويلُ عليه، فإنَّ تحديديَ واكتسابيَ للقيمِ الأخلاقيةِ الصائبةِ أولًا، ومحافظتي عليها والالتزامِ بها ثانيًا، سيكونُ أمرًا أكيدا، وهو ما نجح الدينُ الحنيفُ في تقديمه لنا بشخصياتِ الأنبياءِ والأوصياءِ والصالحينَ من أصحابهم، لذلك فإنَّ فصلَ الدينِ يعني عدمَ وجودِ قدوةٍ في الأخلاق، وعدمُ وجودِ القدوةِ في الأخلاق يَجُرُّ إلى البحث عن قدواتٍ ليست مؤهَّلةً، تتمثَّل في شخصياتٍ تفتقرُ أساسًا إلى القيم الأخلاقية، وهو الأمرُ الذي يُشَكِّلُ تهديدًا حقيقيًّا لحياة الأخلاقِ واستمراريتِها للأجيال القادمة.
الخاتمة:
تَبَيَّنَ جَليًّا أنَّ الأخلاقَ جُزْءٌ لا يَتجزَّاُ من الدين، منصهرةٌ في تعاليمه ومُصنَّفةٌ بوضوح، وأنَّ الدينَ هو العامِلُ على بقائها واستمرارِها وانتشارِها، ولولا الدينُ لَذَهَبَتِ اْلقِيَمُ كُلُّها أدراجَ الرياحِ، وإذا وَعَيْنا ذلك نَعرِفُ أنَّ ارتباطَ الأخلاقِ بالدينِ يجعلُ الحديثَ في سِياقِ الأخلاقِ ليس مجردَ نظرياتٍ ومعلوماتٍ وقواعدَ في الذهنِ للقراءةِ أو الكتابة فَحَسْبُ، ثُمَّ متى ما تصادَمَت مع الأهواءِ والمصالِحِ ضُرِبَ بها عَرْضَ الحائطِ، بل هو حديثٌ عن ممارسةٍ ينبغي تطبيقُها في الواقع العمليِّ على نحوٍ جِدِّيٍّ في الخارج، بخلافِ أولئك الذين يرون أنَّ الأخلاقَ مُنْفَكَّةٌ عن الدين، وفي واقعِهِمُ اْلملموسِ لا يعملونَ بهذه القيم، وإنْ عملوا بها لفترةٍ فإنَّ أهواءهم ومصالِحَهُمْ تُسقِطُهُمْ في النهاية في مستنقع اللا قيمِ واللا أخلاقِ، والقصصُ في ذلك كثيرةٌ لسنا في مقامِ سردِها.
كما أنَّه على الرغم مِنْ تَنَوُّعِ الآراءِ فيما بينَ مدرسةِ الفلاسفةِ ومدرسةِ الأخلاقيينَ ومدرسةِ المتكلمينَ؛ إلا أنَّه يجدرُ مع كلِّ هذا مراعاةُ الإخلاصِ وحبِّ الخيرِ وحُسنِ النِّيَّةِ على المستوى العمليِّ في حياتنا، الإخلاصُ وحبُّ الخيرِ وحُسنُ النيةِ كَقِيَمٍ من القيمِ الأخلاقيةِ فريدةٍ وثمينةٍ ومهمة، حيث إنَّ شخصًا من سوادِ الناسِ قد لا يَعِي بدقةٍ هذه الفروقاتِ التي ذكرناها في النقاشاتِ النظريةَ المحتدمةَ، ولا يفهمُ على نحوِ الضبطِ والتحديدِ الفروقاتِ بينَها ولا ما يجري تمامًا فيها، ولكنه على المستوى العمليِّ يُدركُ جيدًا أهمية الالتزامِ بما لديه من القيم الأخلاقيةِ والفضائل، ويستحيلُ أنْ يُفَرِّطَ فيها ويتنازلَ عن مبادئِه، بينما قد يكونُ في قباله شخصٌ مُحَنَّكٌ خاضَ نظريًا في كل تفاصيلِها، وعَرَفَ أسرارَها وسَبَرَ أغوارَها، ولكنَّهُ عمليًّا لا يتحلى بشيء من هذه القيم الأخلاقيةِ مع الأسفِ، الأمرُ الذي يدعو للتأملِ والتدبرِ بجديةٍ في حالِ النفسِ وباطنِها، حيث إنَّ الأخلاقَ تحكي عن هذا الباطنِ، وإذا لم يَكُنِ اْلباطنُ حسنًا وسليمًا فَلَنْ يَكونَ عالِمًا عامِلًا بما يعلَم، وبالتالي سيتهاوى إلى غياهب الظُّلْمة، ولَطَالَما أثبتَ لنا التاريخُ أنَّ الأُمَمَ التي زاغَتْ عَنْ هذهِ القيمِ آلَ مَآلُها إلى ما لا يُحمَدُ عُقباهُ، ونالَهُم سوءُ العاقبةِ شرَّ منال.
والحمد لله رب العالمين وصلِّ اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
عبد الله المري
9.2024
المصادر والمراجع:
الكافي – كتاب العقل والجهل – جنود العقل وجنود الجهل – الشيخ الكليني
https://ar.lib.eshia.ir/11005/1/10
رسالة في التحسين والتقبيح - الشيخ جعفر السبحاني - الصفحة 143
https://ar.lib.eshia.ir/26459/1/143
هل نحن بين (أخلاق بلا دين) و(دين بلا أخلاق)؟ - السيد منير الخباز
https://almoneer.org/index.php?act=artc&id=2306
القـــدوه أهميتهــــا ودورهــــا – د.علي الحاج حسن
https://www.almaaref.org/maarefdetails.php?id=14639